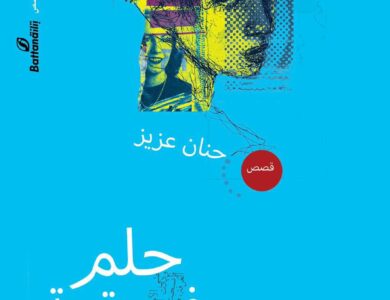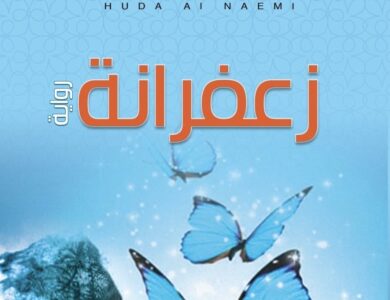د. شهد هشام الشنديدي .. تقرأ في «كبوحِ نايٍ قديم» للكاتب المبدع كرم الصباغ

الحياة مدرسة يتعلم فيها الكبيرُ والصغير, فيها تُصقل المهارات وبتجاربها ينضجُ الإنسان.
وهذه المدرسة نبعٌ خصبٌ لكلِ أديبٍ يستقي منها أفكَارَه, ويعبرُ بقلمِهِ عن تجاربها، وأديبنا كرم الصباغ باهرٌ وماهرٌ في التعبير عن تجاربِ الحياة.
ففي هذه المجموعة القصصية المتفردة عزف الكاتبُ على وترِ الشجن, وذكر مآسي وآلام الحياة.
فجاءت بعنوانِ كبوحِ نايٍ قديم.
وجعل هذا العنوانَ معبرًا بصدقٍ عن جميع القصصِ؛ فهو ليس عنوانُ قصةٍ من مجموعته, ولكنه يعبر عن الجِذعِ الذي تفرعت منه جميعُ القصص.
فحملت القصصُ في ثناياها شجنًا لطيفًا يَهزُ الوجدانَ ويترك بصمته في قلبِ القارئ.
واستخدامُ النايِ في العنوانِ تعبيرًا عن هذا الشجنِ, فالنايُ آلةٌ موسيقيةٌ تعبرُ عن الأنينِ, ويوصفُ صوتُه بالصوتِ الشجيِّ العذبِ.
كما لبستْ قصصُه ثوبَ الذكرياتِ, وما فيها من أصالةٍ وتفردٍ عزيزٍ على التَّكرارِ, ومن هنا كان النايُ قديمًا.
وهذه الذكرياتُ فيها من الأسرارِالكثير, والتي تحتاجُ إلى مَنْ يكشف اللثام عنها؛ فجاءت المجموعةُ القَصصيةُ لتبوحَ بهذه الأسرار.
كبوحِ نايٍ قديم تتكونُ من قسمينِ: القسمُ الأول: بعنوان” لحنٌ قديمٌ يَجْلُو الصدأ”. حوى ثلاثَ عشرةَ قصةً.
القسم الثاني: بعنوان “لَحْنُ الْبَوَارِ”. حوى تسعَ قصصٍ.
واللحنانِ خرجا من نفس النايِ القديمِ يحملان الشجنَ وعبقَ المشاعرِ الملتهبةِ.
المجموعةُ الأولى جاءت محملةً بأشجانٍ كثيرة كصدماتٍ تحيي القلبَ وتجلو قسوتَه, وعلى الرغم من ذلكَ ففيها السعادةُ وراحةُ البال, وكانَ مكانُها النجعَ، وما يحملُه من أصالةٍ وعراقةٍ, فيه الطبيعةُ الصافيةُ الخلابةُ, ونقاءُ السريرةِ, والعلاقاتُ الطيبةُ بين الناسِ, البساطةُ, الهدوءُ, وغيرُها كثير.
والمجموعةُ الثانيةُ “لحنُ البوارِ” أي لحنُ الخرابِ, ومكانُها المدينةُ التي لا يضحكُ فيها أحدٌ, ولا أحدٌ يشعرُ فيها بآلامِ الغيرِ, ففيها كلُّ ما يؤرقُ الإنسانَ من آلامِ الفراقِ وحزنِ النهاياتِ, ذكرياتُها مستعملةٌ, وظروفُ معيشتِها قاسيةٌ, فيها الفشلُ وخيبةُ الأملِ, وغيرُها كثير.
ولعلَّ الإشارةُ هنا إلى الفرقِ بين الريفِ والحضرِ، فالريفُ مليئٌ بالنقاءِ والطيبةِ والتَّؤُدَةِ والبساطةِ، والمدينةُ متسارعةُ الأحداثِ ليس فيها متسعٌ للاستمتاعِ بالحياةِ، كلٌّ مشغولٌ بنفسِه ولا يلتفتُ للآخرين، فكثرتْ فيها المشاعرُ السلبيةُ والإحباطاتُ والفشلُ.
صوَّرَ مبدعُنا في مجموعتِه القصصيةِ الكثيرَ من المشاعرِ الإنسانيةِ؛ فيها الحنينُ لأيامِ الصَّبا كقصةِ “دور سيجا”, فبطلُ القصةِ يعيشُ وحيدًا في ذكرياتِه القديمةِ رافضًا قبولَ فكرةِ تخلي رفاقِه عنه، يقولُ الكاتبُ على لسانِ بطلِه فيخشى: “أن يكونَ قد هانَ عليهم جميعًا, فاجتمعوا سرًّا بدونِه, في مكانٍ لا يعلمُه؛ ليجرِّبوا لُعبةً جديدةً, تعيدُ إلى أوراقِهم المُصفرةِ الاخضرارَ, بينما تركُوه وحيدًا, يتلهى بالغناءِ, واجترارِ الذكرياتِ!” ص 11
وفيها حنينُ وشوقُ الأبِ لابنِه في قصةِ “الْبَيَّارَة” الذي خرجَ ذاتَ صباحٍ ولم يعدْ؛ فظلَّ مصيرُه مجهولًا.
وفيها الشعورُ بالظلمِ والقهرِ، وكيفَ يتحولُ الإنسانُ من شخصٍ محبِّ للحياةِ يساعدُ كلَّ من حولَه دونَ كللٍ أو مللٍ إلى شخصٍ يعاني من ظلمٍ وافتراءٍ غيرِ مبررٍ فيعرِّضُه لصدمةٍ تدمرُه وتقضي عليه بلا شفقةٍ أو رحمةٍ، كما حدثً مع بطلةِ قصةِ “رَجْمُ الحِنًّاءِ” تلكَ المرأةُ “المفعمةُ بالحياة, تجذبُ إليها الأنظارَ من أولِ وهلةٍ. نقشُ الحناءِ عملٌ واحدٌ من أعمالٍ شتى تتقنُها؛ فهي تبيعُ العطورَ, وملابسَ النساء, وأدواتِ الزينةِ.” ص 17, 18
وشاءتْ الأقدارُ وتُوفِّي زوجُها وأصبحتْ الشائعاتُ تحومُ حولَها فيحجمُ عنها طلابُ الحلالِ, وغارتْ منها النساءُ، ولكنَّها كانتْ على عهدِها القديمِ، كأنَّ زوجَها مازال حيًّا؛ تزينُ العروسَ بيديها, وتجاملُ الجيرانَ في السراءِ والضراءِ.
وفي نهارٍ مترَّبٍ برياحِ الخماسين, خرجتْ لشراءِ بعضَ احتياجاتِها, إذ بشبابٍ لا ضميرَ لهمْ اعترضوا طريقَها وانهالُوا عليها بالتهمِ الباطلةِ، وقتَها علمتْ ما خفيَ عليها منذُ سنين, غضبتْ كما لم تغضبْ من قبل, حاولتْ بكلِّ ما أوتيتْ من قوةِ الدفاعِ عن نفسِها, استنجدتْ بأهالي النجعِ, لكنَّ أحدًا منهمْ لمْ يُغثْها, بلْ لاذُوا جميعًا بالصمتِ.
تحاملتْ على نفسِها وقاومتْ صدمتَها, ونهضتْ من جديدٍ واختفتْ عن أنظارِ النجع.
وكأنَّ لعنتَها أصابتْ أهالي النجعِ فتبدَّلَ حالُه من السعادةِ والفرحِ إلى الحزنِ والكآبةِ فانطفأتْ العرائسُ, ما عُدنَ لامعاتٍ, وتحوَّل دارُها – أي دارُ الأرملةِ – التي كانتْ تسكنُه إلى الوحشةِ والسكونِ.
وفيها بعضُ الجراحِ التي لا تندملُ قطَّ، كجِراحِ ذلك الشابِّ الغضِّ في قصةِ “جِراح” الذي وجدَ نفسَه تائهًا كسائرِ أفرادِ فرقتِه وَسْطَ هرجِ ومرجِ الانسحابِ المفاجئِ في نكسةِ الخامسِ من يونيو عام 1967, فيصفُ الكاتبُ ببراعةٍ شديدةٍ حالتَه النفسيةَ السيئةَ التي يعاني منها، إذ يقول: “كانَ مثلَهم تمامًا موجوعًا, غارقًا في الخزيِ والمرارةِ؛ فظلَّتْ الأسئلةُ بكماءَ حبيسةً مقيدةً في ذهنِه المشوَّشِ؛ فلمْ يَدْرِ البتَّةَ كيف نُقِلَ من الجحيمِ إلى الجحيمِ.” ص 23, وعلى الرغمِ من أنَّه صارَ كهلًا ورُغمَ صمتِه الطويلِ إلا أنَّه كانَ يثورُ لأتفهِ الأسبابِ, ولكنَّه سئمَ الصمتَ الطويلَ ودعا أصدقاءَه القدامى أنْ يشاركوه مجلسَه أمامَ دكانِه, وكلما تابعَ معهم نشراتِ الأخبارِ وما فيها من مآسي وغاراتٍ على المدنِ المأهولةِ بالنساءِ والأطفالِ والشيوخِ؛ كانَ الغضبُ يغلي في قلبِه, وعروقِه, وكانَ يشخصُ كلَّ مرةٍ ببصرِه إلى السماءِ, فيبصرُ الحمائمَ البيضاءَ ذاتَها, تصيبُها الأعيرُة الناريةُ؛ فتفلتْ مناقيرُها أغصانَ الزيتونِ, وتسقطُ مضرجةً بالدمِ, وقد استحالَ ريشُها الأبيضُ إلى الحُمْرَةِ القَانيةِ, التي تشبُه تمامًا لونَ الدماءِ, التي باتتْ تتفجرُ كلَّ ليلةٍ من ساقِه المبتورةِ, وجروحُه الحيَّةُ الطازجةُ, التي لم تندملْ قط.”ص24
وجرحُ الأبِ المكلومِ لفقدانِ ابنتِه في قصةِ “مَعَارِجُ الْغِزْلَانِ” الذي لاذَ بالصمتِ والعزلةِ في مكتبِه بعد أن صارَ الكلامُ شوكًا في حلقِه، “وصارت الوجوهُ مرايا مهشمةً, لا يستبينُ ملامحُ أصحابُها, ولا يرغبُ في مجالسةِ أيٍّ منهم”.
وصَدقَ مبدعُنا في وصفِ مشاعرِ الأبِ وصفًا مؤثرًا تُدمَى له القلوبُ, فحقًا الابنُ هو فلذةُ الكبدِ والروحِ, وفقدانُه يطفئُ الروحَ ويكسرُ القلبَ, فهم زينةُ الحياةِ الدنيا, ولا شيءَ أصعبُ من فقدانِهم.
ونجدُ في قصةٍ أخرى تحملُ عنوانَ “أُعْشَاشٌ” ألمُ فقدانِ الأمِّ لابنِها على الرغمِ من أنَّه على قيدِ الحياةِ, ونشعرُ فيها بحجودِ بعضِ الأبناءِ على آباءِهم فهذا الابنُ لم يراعِ شعورَ أمِّه وهَجرَها, ولمْ يفكرْ فيها، وإنِّما فكرَ في مصلحتِه فحسب, وأبدعَ الكاتبُ في وصفِ مشاعرِها الداخليةِ الحزينةِ إذ يقولُ: “لقدْ كنتُ تلكَ المرأةَ, التي هزمَها الحزنُ بعدَ أنْ فقدتْ الزُّوجَ, وعندما شَبَّ ولدي, وصارتْ العينُ تستحي من النَّظرِ إلى وجههِ المليحِ, كنتُ على موعدٍ مع مرارةٍ أخرى أشدّ؛ فقد أخبرنِي ذاتَ مساءٍ بأنَّ ساعةَ الفراقِ قد حانت, وبأنَّه قرَّر أن يتجهَ غربًا؛ كي يعبرَ الحدودَ, والأسلاكَ الشَّائكةَ حبوًا مستترًا بظلامِ اللَّيلِ؛ إذْ لَمْ يكنْ يملكُ تأشيرةَ دخولٍ, أو حتى جوازَ سفرٍ. كان قرارُه قاطعًا بلا رجعةٍ, أخبرنِي بأنَّه يأملُ أنْ يَجِدَ في الجهةِ المقابلةِ عملًا, يُدِرُّ عليه دخلًا يعوضُنا عن سنواتِ الحرمانِ, أو أنْ يصادفَ امرأةً, يحصلُ بعد زواجِه منها على أوراقٍ, تتيحُ له إقامةً دائمةً”.ص52
في هذا المقطعِ نكادُ نسمعُ بكاءَ ونحيبَ الأمِّ على ابنِها الذي اختارَ تركَها والتخلي عنها, بنبرةِ صوتٍ تكسوهُ المرارةُ والحزنُ وخيبةُ الأملِ التي أصابتها, وفيه أيضًا إشارةٌ إلى فكرِ بعضِ الشبابِ ممن يفضلونَ الهجرةَ غيرَ الشرعيةِ لتحقيقِ أهدافِهم بطريقةٍ سهلةٍ دونَ حسابِ المخاطرِ التي من الممكنِ أن يتعرضوا لها.
وتقولُ متأوهةً في موضعٍ آخر: “.. آهٍ, يا ولدي العَجُول, يبدو أن السَّنواتِ لم تغيِّرْك البتة.” ص55 وذلكَ عندما عادَ من السفرِ بعد سنواتٍ دونَ أنْ يفكرَ مرةً واحدةً في التواصلِ مع أمِّه للاطمئنانِ عليها وليطمئِنَها عليه, بل ويريدُ أن يأخذَها معهُ للمِّ الشملِ, فما كانَ منها إلا أنَّها تركتهُ ودخلتْ غرفتَها, وأوصدتْ البابَ خلفَها, في إشارةٍ إلى أنَّها غيرُ راضيةٍ عن هذا الوضعِ.
وفي هذه القصةِ طرحَ الكاتبُ سؤالًا وجوديًّا يجعلُ القارئَ يفكرُ بعمقٍ؛ لأنَّه لمسَ شيئًا عنده, إذ يقولُ: “هل تكفي الكلماتُ للاعتذارِ, حينما يكونُ الثًّمنُ الذي دفعناه مرارةً بحجم جبلٍ؟! فمَنْ منا لم يسألْ نفسَه هذا السؤالَ!!!
ونجدُ جحودَ الأبناءِ على الآباءِ في قصةٍ أخرى قصةِ “سحاب صالح” فبناتُ مرزوق زوجِ أمِّ صالح وافقنَ على ما فعلَه أزواجُهن, حيثُ تفاجأَ مرزوقُ ذاتَ صباحٍ “بأزواجِ بناتِه, يقتحمونَ عليه غرفتَه, ويحملونَه هو وزوجتَه, وطفلَه الرضيعَ إلى الخارجِ, وما هي إلا لحظاتٌ حتى وصلتْ بهم إحدى السياراتِ إلى أطرافِ النجع, حيث تقبعُ دارٌ طينيةُ ضيقّةٌ معرَّشةٌ بالسَّعفِ والجريدِ, كان مرزوقُ قد اشتراها من سنينَ, ولكنَّها ظلتْ مغلقةَ الأبوابِ, وهناك ألقُوُه على فراشٍ بائسٍ, في حينِ جلستْ زوجتُه بجوارِه تبكي,” ص34, ولكنْ على الرغمِ من عيوبِ مرزوقٍ إلا أنَّ صالحًا ظلَّ بجوارِه, وفي أيامِه الأخيرةِ أوصى صالحًا قائلًا: “كن جدارًا للرضيعِ وأمِّه, إذا ما سقطَ جدارِي, لا أأتمنُ غيرَك؛ فلا أحدَ في النجعِ مثلُ أبيك.”ص 35, وكأنَّ الكاتبَ يريدُ أنْ يقولَ مَن زرعَ حصدَ.
وفي مجموعتِه القصصيةِ نجدُ أيضًا الشعورَ بالضياعِ وانعدامِ الأملِ في الحياةِ خاصةً إذا فشلَ الإنسانُ في تحقيقِ حلمِه، كذلكَ الشابِّ في قصةِ “غَروب تدريجيٌّ” الذي كانَ حلمُه أنْ يصبحَ معيدًا في كليتِه، وكان أصدقاؤه يلقبونَه بـ”الدكتور”.
ولكنْ يفاجئُنا الكاتبُ في نهايةِ القصةِ بتبدلِ حالِه رأسًا على عقب, فنجدُ أحدَ المارةِ يساعدُ الشابَّ في النهوضِ عندما تعثرتْ قدماهُ في درجاتِ سلمِ الجزارِ, يقولُ: “يمدُّ إليه الرجلُ يدَه, تعودُ, وقد تلطًّخَتْ ببقايا الطِلاءِ العالِق بملابسِ الشَّابِّ, الذي اكتسى وجهُه بالحزنِ والوجومِ وبعضِ التجاعيدِ على غيرِ أوانٍ”. ص 105
وقصةُ “في قلبِهِ زَهْرَةٌ عَبًّادٍ” تحكي مأساةَ شابٍّ فقدَ حبيبتَه نتيجةً لتحكمِ الأهلِ, وتغليبِ مصلحةِ الأبِ على سعادةِ ابنتِه, وهي قضيةٌ اجتماعيةٌ تعاني منها بعضُ الأسرِ في كلِّ وقتٍ ومكانٍ.
ومن القضايا الاجتماعيةِ الهامةِ التي عرضَ لها الكاتبُ وسلطَ الضوءَ عليها؛ معاناةُ المعلمِ في مهنتِه، متمثلًا ذلك في قصة “عَصَافِيرُ جَهَنَّمَ” ويمكنُ اعتبارُها خيرَ مثالٍ للقصصِ السيكولوجيةِ التي تصورُ مشاعرَ الإنسانِ وأفكارِه, وتعكسُ أفكارَه الداخليةَ وتصلُ إلى أعماقِ النفسِ البشريةِ.
فالعنوانُ في حدِّ ذاتِه يثيرُ التساؤلَ لدى القارئِ كيفَ تجتمعُ العصافيرُ – والمعروف عنها الوداعةُ – وجهنمُ – والتي هي الجحيم- ؟!, والعصافيرُ هنا ترمزُ إلى تلاميذِه, ولكنَّها بالنسبةِ له جهنمُّ, فلا يستطيعُ الاستمتاعُ بهم؛ لأنَّه يعيشُ مأساةً حقيقيةً, وظروفًا اجتماعيةً قاسيةً لا يتحملُها.
تحكي القصةُ مأساةَ مُدَرِّسِ رسمٍ في مدرسةٍ ابتدائيةٍ, يتعرضُ لضغوظاتٍ كثيرةٍ, يعاني من الفقرِ والإحباطِ, راتبُه هزيلٌ لا يكفي احتياجاتُه واحتياجاتُ أسرتِه المكونةِ من زوجتِه وولديه.
واختيارُ الكاتبِ هنا لمهنةِ معلمِ الرسمِ بالتحديدِ كنوعٍ من السخريةِ إذ أنَّه من المعروفِ أن الرسمَ يعني الألوانَ والبهجةَ والسعادةَ والفرحةَ, ولكنْ هنا مدرسُ الرسمِ يعاني من مهنتِه ويدخلُ في صراعٍ نفسيٍّ رهيبٍ بينَ حبِّه للرسمِ ورغبتِه في تحقيقِ حلمِه, وبينَ مسئولياتِه التي لا يُعينُه عليها راتبُه الذي لا يكفيه, فيشعرُ بالعجزِ وقلةِ الحيلةِ، خاصةً في نهايةِ كُلِّ شهرٍ ميلاديٍّ, ومع مرورِ الأيامِ ضاقتْ زوجتُه بفقرِه, وأخذتْ تعايرُه وتذكرُه بحالِ قريباتِها في كلِّ مناسبةٍ, فترشقُه بنظراتٍ صادمةٍ لا يقدرُ عليها, فتدفعُه في كثيرٍ من الأحيانِ إلى إلقاءِ فرشاتِه وألوانِه جانبًا، فيحاولُ بشتى الطرقِ بيعَ لوحاتِه التي رسمَها لكنْ دونَ فائدةٍ؛ حيثُ تحوَّلَ إلى إنسانٍ مسالمٍ أو سلبيٍّ يؤثرُ السلامةَ، حتى إنَّه لم يطالبْ بأقلِّ حقوقِه, وأصبحَ شاردًا لا يبصرُ سوى العدمِ والفراغِ, يعيشُ حالةً نفسيةً سيئةً, وكانتْ نهايتُه مأساويةً قاسيةً؛ حيث تحولَ في النهايةِ إلى “خِرَقِ قماشٍ ممزقة, وقطعِ جلدٍ بشريٍّ, وبقعِ دماءٍ قانيةٍ, لراكبٍ تشقًّق جسدُه للتو؛ فاندفعتْ من داخلِه مئاتٌ من العصافيرِ السجينةِ, التي حلقتْ بعيدًا, وشقًّتْ طريقَها إلى مكانٍ سريٍّ ظليلٍ, تسكنُه روحٌ, خاصمتْ صاحبَها منذُ سنين”. ص111
وصفٌ رائعٌ دقيقٌ – على الرغم من قسوتِه – يعبرُ بصدقٍ عن مأساةٍ يعاني منها الكثيرُ في وقتنا الحالي, وتعتبرُ هذه القصةُ جرسَ إنذارٍ للفتِ الأنظارِ إلى مَن يعاني مثل هذه الظروفِ القاسيةِ, ومحاولةً لتحسينِ وضعِهم بطريقةٍ أو بأخرى, وهي آخرُ قصةٍ في المجموعةِ وممكنْ أن نقول: إنَّ ختامَها مسكٌ.
وكلُّ هذه المشاعرِ الإنسانيةِ والأزماتِ والمآسي التي عانتْ منها شخوصُ قصصِ مبدعِنا, نعيشُها نحن بشكلٍ أو بآخر.
فبرعَ مبدعُنا في وصفِ شخوصِه لإظهارِها, وأعانَ القارئَ بذلك على رؤيتِها وتخيلِها, فركزَ على الجانبِ النفسيِّ, أو بعبارةٍ أخرى على الوصفِ الداخليِّ للشخصياتِ, فنجدُ وحدةَ الأثرِ النفسيِّ متوفرةً إلى حدٍّ كبيرٍ في قصصِ كرمِ الصباغ.
بناءُ قصصِ كرم الصباغ
في كل قصةٍ من قصصِ الصباغ نجدُ تصويرًا لحادثةٍ ما منْ حوادثِ الحياةِ التي نحياها، أو وصفًا لعدةِ حوادثَ مترابطةٍ، تَعمقَ الكاتبُ في تقصِّيها والنظرِ إليها من جوانبَ متعددةٍ تخالفُ النظرةَ السطحيةَ أو الروتينيةَ المعتادةَ؛ فأكسبَها قيمةً إنسانيةً خاصةً.
كما قدمَ فكرتَه في تسلسلٍ منطقي تخللَها بعضُ الصراعاتِ والعقباتِ والأزماتِ بطريقةٍ مشوقةٍ بعيدةٍ كلَّ البعدِ عن الرتابةِ والمللِ.
فنستطيعُ أن نقولَ: إنَّ قصصَ الصباغِ توافرتْ فيها خصائصُ القصةِ القصيرةِ بشكلٍ كبيرٍ من حيثُ التركيزُ, فكلُّ قصةٍ تدورُ حولَ موضوعٍ معينٍ أو فكرةٍ واحدةٍ, وعددُ الشخصياتِ الموجودُ في كلِّ قصةٍ قليل, فلم يقدمّ الكاتبُ شخصياتٍ غيرَ ضروريةٍ للقصةِ.
وعنْ بنيةِ وهيكلِ القصصِ نجدُ أنَّها موفقةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ من حيثُ البداياتِ والوسطِ والنهاياتِ, وهو ما يسمى بنسيجِ القصةِ.
فبرعَ مبدعُنا في بداياتِ قصصِه والتي تبدأُ من العتبةِ الأولى (العنوان)، فعنوانُ كلُّ قصةٍ مختارٌ بعنايةٍ شديدةٍ, عناوينُ غيرُ تقليديةٍ جاذبةٌ للقارئ, تثيرُ فضولَه لسبرِ أغوارِ القصةِ للوصولِ إلى مرادِ الكاتب.
وعن بدايةِ كلِّ قصةٍ فنجدُّها تنوعتْ من قصةٍ لأخرى، فبدأَ مرةً بالحدثِ مباشرةً كما في قصةِ دور سيجا, إذ يقولُ: “عادةً ما يستظلونَ بظلالِ أشجارِ الجازورينَ عصرَ كلِّ يومٍ؛ فيفترشونَ الرَّملَ, ويشكلونَ بأجسادِهم حلقةً كبيرةً, داخلُها يجلسُ لاعبانِ وجهًا لوجه, يفصل بينهما رقعة “سيجا” ذات مربعاتٍ متجاورةٍ, رُصَّتْ داخلَها حصواتٌ, يحركُها اللاعبانِ بحذرٍ.”ص9
ومرةً بالشخصيةِ, كقصةِ جراح، وسحاب صالح، حيث بدأها بقوله: “”صالحٌ” وسطٌ في الطولِ, معتدلُ القامةِ, يحملُ وجهُه الأسمرُ شاربًا محفوفًا, ويحملُ رأسُه الشامخُ شَعرًا كلونِ الفحمِ. وسيمُ الوجه, تحبُّ العينُ رؤيتَه. هادئُ الطبعِ رزينٌ, يمشي بخطواتٍ وئيدةٍ؛ فتضافُ إلى سنواتِه الخمسِ والعشرينَ عشرينَ أخرى على أقلِّ تقديرٍ.” ص 31, هنا وصفٌ داخليُّ وخارجيٌّ للشخصية.
وفي قصة صهيل خافت بدأ بالزمن إذ يقول: “يُحشرونَ من الثامنةِ صباحًا حتى الثانيةِ ظهرًا في ذاتِ الحجرةِ, التي تشبهُ سائرَ مكاتبِ ديوانِ الإدارةِ بطلائِها الرماديِّ الكالحِ”ص91
وكما برعَ الكاتبُ في بداياتِه برعَ في نهاياتِه, فللنهايةِ في القصةِ القصيرةِ أهميةٌ خاصةٌ؛ إذ هي النقطةُ التي تتجمعُ فيها الاحداثُ وتنتهي إليها الخيوطُ كلُّها؛ فيكتسبُ الحدثُ معناهُ الذي يريدُ الكاتبُ الإبانةَ عنه, وهي ما تسمى لحظةُ التنويرِ, وهي تنويرُ القارئِ بمرادِ الكاتب، لا سيما إذا جعلَها الكتابُ نهايةً مشوقةً وغيرَ متوقعةٍ.
فتكادُ تكونُ نهايةُ كلِّ قصةٍ من قصصِ الصباغِ نهايةً مفاجأةً للقارئِ غيرَ متوقعةٍ, ولكنَّها معقولةٌ, فعلى سبيلِ المثالِ: نهايةُ قصةِ الْبَيَّارةً والتي تحكي قصةَ الأبِ الذي فقدَ ابنَه وبحثَ عنه في كلِّ مكانٍ فجاءَه صوتٌ يدعوه إلى الاقترابِ من البيارة, وهناك سوفَ يرى من يشتاقُ إلى لقياه. “وما إن يقتربْ منَ الطوقِ الحجريِ المبنيِّ على حافتِها, حتى تجذبَه يدٌ خشنةٌ؛ فيهوي إلى الأعماقِ المظلمةِ السحيقةِ, وعندما يصلُ إلى القعرِ, تتلقفُه أيادٍ أخرى, تدفعُه إلى سردابٍ, ما إن يعبرْه, حتى يتفاجأَ بولدِه, يجلسُ على عرشٍ من الأبنوسِ المرصّعِ بالذهبِ, والجوهرِ, بينما تجلسُ بجوارِه أنثى تضوي كالشمسِ, تنحني لها صفوفٌ من الجنيات”. ص 29.
فهي نهايةٌ غيرُ متوقعةٍ, يمكنُ اعتبارُها من الميثولوجيا وهو نمطٌ من أنماطِ القصةِ القصيرةِ يتحققُ فيه المزجُ بين الأساطيرِ القديمةِ والزمنِ المعاصرِ، والصباغُ هنا حررَ الأسطورةَ القديمةَ من جمودِها وقيودِها الزمنية والمكانيةِ وعرضَها بروحٍ عصريةٍ وأسقطَها على الواقعِ, وفي أغلبِ ظنِّي أن مبدعَنا كانَ متأثرًا بأسطورةِ شاهميران, وهي أسطورةٌ من التراثِ الكردي.
ومن النهايات الصادمة نهايةُ “هَوَاءٌ رَاكدٌ” فبعدَ أن فرحنا لفرحِ البطل, وبعد أن أرقصَ الفرحُ قلبَ الزوجِ وقلوبِنا معه؛ لأنَّه أخيرًا سيرزقُ بالطفلِ الذي يتمناهُ هو وزوجتُه بعدَ أنْ بشرتْه بحملِها المفاجئِ؛ يفاجئُنا الكاتبُ بنهايةٍ صادمةٍ بقوله: “إذ وجدَ نفسَه لا يزالُ في فراشِه, تطبقُ عليه العتمةُ من كُلِّ جانبٍ؛ فراحَ يلتهمُ الظلامُ بعينيهِ, وبعدَ لحظاتٍ من التحديقِ استطاعَ أنْ يبصرَ الخزانةَ المغلقة, في حينِ سمعَ نحيبَ زوجتِه؛ فراحتْ عيناهُ تفتشانِ عنها؛ فأبصرَها متكورةً في ركنٍ باردٍ من أركانِ الغرفة, وأبصرَ جسدَها يهتزُّ؛ إذْ كانتْ منخرطةً في نوبةٍ من نوباتِ البكاءِ الحارِّ.”ص58 لنكتشفَ أنَّه كانَ يحلُمُ.
جاءت المجموعةُ القصصيةُ بلسانِ الراوي العليمِ والساردِ المشاركِ في الحدثِ, فنجدُه مرةً داخلَ النص, ومرةً خارجَه, وعندما يكونُ في الداخلِ يتحولُ إلى شخصيةٍ من الشخوصِ المنتجةِ للأفعالِ, فعلى سبيلِ المثالِ نجدُ في قصةِ “مَعَارجُ الْغًزْلَانِ” الروايَ هو بطلُ القصةِ الأبُ يقولُ: “هذا أنا.. أجلسُ على مكتبي, أمامِي أوراقٌ شاغرةٌ, أٌقَلِبُ بصري في دوائرِ الدخانِ المتصاعدةِ من سجائرَ, أُشعلُها الواحدةَ تلوَ الأخرى, أطردُ أنفاسها, فَتَخْرُجُ, وقدْ اختلطتْ بأنفاسِي الحارقةِ.” ص71
وقصةُ “غِوَايَةُ” الراوي أيضًا بطلُ القصةِ ومشاركٌ في الحدث, يقول: “ها قد انتهيتُ منها أخيرًا, أراجعُ ما كتبتُ بعينينِ مرهقتينِ, ومع آخرِ سطرٍ أقرأُه تغمرني نشوةٌ خفيةٌ, سرعان ما تتبدد بمجرد أن أتطلعَ إلى هاتفِي, فيصيبُني الفزعُ؛ إنها الرابعةٌ صباحًا, لقدْ سرقني الوقتُ كالعادةِ, ماذا تفعلُ ساعتانِ من النومِ ببدنِ رجلٍ, ينتظرُه يومٌ طويلٌ من العملِ الشاق؟! أُسرعُ إلى سريري, أدفنُ رأسي بين وسادتينِ, أتوسَّلُ إلى النومِ أن يأتي”. ص 75, وغيرها.
وفي قصصٍ أخرى نجدُ الراوي خارجَ العملِ وتنحصرُ مهمتُه في إنتاجِ الأقوالِ, فعلى سبيلِ المثالِ قصةُ “مِثْلُ وردةٍ جوريةٍ” الساردُ أو الراوي خارجُ الحدثِ يقول: “تهبطُ من إحدى السيارات التي دخلتْ الموقفَ للتو, تنجذبُ إليها الأعينُ. أربعينيةً, طويلةُ, بيضاءُ, تسترُ جسدَها الممشوقَ عباءةُ سوداءٌ, وتتدلى خصلاتُ شعرِها الناعمِ من تحتِ طرحتِها الخضراء, عيناها أخلصتَا للضدينِ الأبيضِ الرائقِ, والأسودِ الحالكِ, فأظهرَ اللوانانِ جمالَ بعضِهما البعض, وأضفيا على عينيها سِحْرًا وجَاذِبيَّةً, يزدانُ وجهُها بشامةٍ أسفلَ ثغرِها العنابي.” ص13, وغيرها, كما أن الوصفَ هنا يؤدِي غرضًا معينًا, فالوصف في القصةِ القصيرةِ لا يصاغُ لمجردِ الوصفِ, بل لأنَّه يساعدُ الحدثَ على التطورِ؛ لأنَّ الوصفَ في الواقعِ جزءٌ من الحدثِ نفسِه, كما يقولُ رشاد رشدي.
أما عن لغةِ المجموعةِ القصصيةِ فهي أهمُّ ما فيها, لغةٌ رائقةٌ شاعريةٌ سلِسلةٌ ناعمةٌ, لغةٌ فريدةٌ من نوعِها, لغةٌ حيةٌ, حتى إننا من الممكنِ أن نعتبرَ مبدعَنا له معجمُه اللغويُّ الخاصُّ به، والذي يميزُه عن غيرِه, تظهرُ فيه بصماتُ الحياةِ التي عاشَها والبيئةُ المحيطةُ به.
اعتمدَ الأديبُ بشكلٍ كبيرٍ على اللغةِ التصويريةِ وخاصةً التشبيه, فهو من الصورِ البلاغيةِ المعروفةِ, والتي لجأَ إليها كوسيلةٍ لتوصيلِ ما يريدُ قولَه لقرائِه, فنجدُ التشبيهَ ينسابُ في قصصِه بصورةٍ سلسلةٍ بسيطةٍ, دونَ أيِّ تكلفٍ أو تصنُّعٍ، مما يدلُّ على أنَّ أديبَنا كاتبٌ متمكنٌ من أدواتِه ومن لغتِه.
ويكثرُ مبدعُنا من استعمالِ أداةِ التشبيهِ (الكاف), و(مثل)، وخيرُ مثالٍ على ذلكَ عنوانُ المجموعةِ “كبوحِ نايٍ قديم”.
ويشبِّهُ سحرَ زخرفِ المرأةِ التي تُزينُ العرائسَ في قصةِ رجمِ الحناءِ بسحرِ عينيها السوداوينِ، مستخدمًا أداة التشبيه الكاف قائلًا: “لِزخرفِها سحرٌ كسحرِ عينيها السوداوينِ” ص 17.
ويشبُّه جسدَها بالأيقونةِ قائلًا: “لها جسدٌ كالأيقونةِ.” ص 17
وقوله في قصةِ صهيل النور: “رَبَا يحيى كعودِ ريحانٍ طيبِ المنشأِ والرائحةِ” ص61, ونفسُ القصةِ يقول فيها: “الوقتُ يُطْوَى سريعًا كقماشةٍ بيضاءَ”. ص60 وغيرِها الكثيرُ والكثيرُ.
وأيضًا استخدمَ أداةَ التشبيهِ “مثل” بكثرةٍ, كقوله: “مثلُ وردةٍ جورية”، وهو عنوانُ قصةٍ من القصصِ, فيشبهُ المرأةَ الأربعينيةَ في القصةِ بالوردِ الجوري الذي كانَ يملأُ حديقةَ بيتِها قبلَ أنْ يُقصفَ ويتحولَ إلى أنقاضٍ.
ويقول في قصةِ جراح: “ولمَّا كانتِ الأيامُ مثلُ الخيولِ تجيدُ الركضَ” ص21, حيثُ شبَّهَ الأيامَ في سرعتِها بالخيولِ التي تجيدُ الركضَ, وهو منَ التشبيهاتِ المعبرةِ حقًّا, وقريبٌ من هذا التشبيهِ ما قاله في موضعٍ آخر في قصةِ غروب تدريجي: “الوقتُ كالطًّرائدِ يجيدُ الفرارَ.” ص105
وفي قصةِ “رفات القمر” شبَّهَ العباراتِ القاسيةَ التي قالتها حبيبةُ البطلِ بالرصاصِ الذي يغلي, يقولُ: “اندفعتِ العباراتُ من فمِها مثلُ رصاصٍ يغلي” ص 66.
وهذا التشبيهُ البديعُ الذي يصورُ فيه مأساةَ أمٍّ وبناتِها في المدينةِ القاسية, في قصةِ ذكريات مستعملة؛ إذ يقول: “لا أحدَ يضحكُ في تلكَ المدينةِ, ولا أحدَ يشعرُ بآلامِ الأمِّ وبناتِها. أُبصرُ الأمَّ وطفلتَها غارقتينِ في الحيرةِ والعجزِ, أبصرُ الأمَّ وطفلتَها مثلَ طائرينِ نحيلينِ يلتقطانِ رزقَهما الشحيحَ من بينِ فكي تمساحٍ يوشكُ جوفُه الأسودُ السحيقُ أن يبتلعَهما.” ص82
تشبيهٌ قاسٍ حيثُ شبَّهَ الأمَّ وبناتِها بطائرينِ نحيلينِ دلالةً على ضعفِهم وقلةِ حيلتِهم في مواجهةِ ظروفِ الحياةِ القاسيةِ، التي شبَّهها بالتمساحِ الحيوانِ المفترسِ.
وغيرُها من التشبيهاتِ البليغةِ التي تزخرُ بها المجموعةُ.
كما يضمُّ المعجمُ اللغويُّ للكاتبِ في هذه المجموعةِ القصصيةِ بعضَ الألفاظِ الاجتماعيةِ التي تعبرُ عن البيئةِ الموجودةِ في القصصِ, والتي في الغالبِ هي بيئةُ النجعِ, وما فيها من عاداتٍ وتقاليدَ وأنماطِ سلوكٍ لسكانِ النجعِ, فعلى سبيلِ المثال: نجدُ مثلًا من عاداتِ المجاملاتِ في الأعراسِ والتي كانتْ تمارسُها المرأةُ التي تزينُ العروسَ في قصةِ رجمِ الحناءِ أنَّها كانت “تحملُ فوقَ رأسِها سبتَ الخوصِ الممتلئِ عن آخرِه بعبواتِ الشاي الأحمرِ, والأخضرِ, وعبواتِ السكر, وزجاجاتِ شرابِ الورد, وأكياسِ الحلوى, تدسُّ المالَ في يدِ أمِّ العروسِ, وتعودُ سريعًا إلى دارِها. وفي المآتمِ تتشحُ بالسوادِ, وتعصبُ رأسَها بطرحتِها السوداءِ, تبكي ميتَهم بحرقةٍ.” ص18
لقد كانَ للبيئةِ أثرٌ جليٌّ في قصصِ كرمِ الصباغ؛ حيث استمدَّ منها مفرداتِ لغتِه ففيها ألفاظٌ مثل: (حصيرةِ السمر- فرنِ الحطب- الحظيرة- برامِ الرز المدسوسِ بالإدامِ والسمنِ البلدي- البقرةِ وحليبِها- البرسيم- مكينةِ الري- وغيرِها…) كما ذكرَ الصحراءَ.