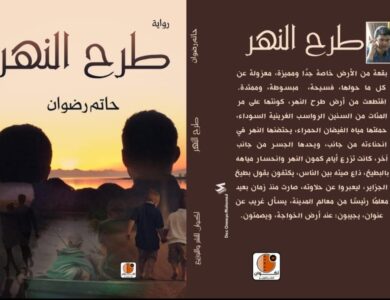قراءة في قصص (كبوح ناي قديم) للأديب كرم الصباغ
د. محيي الدين صالح عبد الحميد .. يكتب: «الذات وانشطارها بين لحنين»

تكشف قصص (كبوح ناي قديم) نوعًا من صراع الذات المبدعة بين أمرين؛ أولهما: صراعها مع الواقع وضغوطاته المستمرة على الذات؛ وثانيهما: يتمثل في محاولة الانتصار على هذا الواقع وتخفيف حدته بالارتماء في أحضان الذكريات والحنين إليها؛ إذ تمثل ملاذه الآمن وحضنه الدافيء للتخلص من معاناته الحياتية في واقع بات مظلمًا بائسًا؛ وأول ما يستوقفنا في كتابه العنوان بوصفه العتبة الأولى من أجل الولوج إلى النص؛ إذ يمثل العنوان هوية النص، وبطاقة التعارف الأولى التي تربط قاريء النص بمبدعه، والعنوان الذي يرتضيه القاص لمجموعته القصصية، يمثل خيطًا حريريًّا متصلًا بصورة ما بين أحداث القصص جميعها أو طريقة بنائها شكلًا ومضمونًا؛ فيختار الأديب إحدى عناوين القصص داخل المجموعة لتكون هي عنوان المجموعة بأسرها؛ فيدخل القاريء أول ما يدخل إلى تلك القصة محاولًا الوقوف على مراد الكاتب وطريقة نسجه لمعمارية مجموعته من الناحيتين المضمونية والفنية على حد سواء؛ وبالنسبة لكرم الصباغ هو لم يختر إحدى قصص المجموعة لتكون عنوان مجموعته؛ وإنما ارتضى أن يضع عنوانًا يكون هو الخيط الذي يضم حبَّات العقد كاملة، وليس واسطة العقد، وأنا؛ وهو بذلك يعطي للقاريء حين يتطلع لأسماء القصص إحساسًا مختلفًا مفاده أن الأديب يكتب هذا العمل وفق فكرة كبيرة دارت وتمركزت في عقله، وباتت تخرج وفق خطة محكمة البناء، شديدة الحساسية والخصوصية، والعنوان: “كبوح ناي قديم” صورة مجازية اعتمدت التشبيه باستخدامه الأداة (الكاف)، لكن هذا التشبيه أتى غير مكتمل الأركان (المشبه-المشبه به- الأداة)؛ إذ حذف المبدع المشبه متعمدًا وذكر المشبه به وأداة التشبيه، مما أعطى العنوان بعدًا جماليًّا، وأغرى القاريء أكثر من أجل اقتحام النص، بغية الوقوف على بعض التفاصيل وخاصة المتعلقة بحال المشبه، وكأن المبدع يبدأ كتابه بسؤال عريض للقاريء وكأنه يتحداه: يا تُرى من الذي بوحه كبوح ناي قديم؟!؛ ثم استخدامه لفظة (بوح) فيها ذكاء شديد ودقة في اختيار اللفظة؛ إذ البوح نوع من أنواع الكلام المستفيض المُعبِّر عن كوامن النفس، وما يختلج داخلها من مشاعر دفينة وأحاسيس حبيسة، وحين تنهي قراءة الكتاب بقسميه تجد أن غياب المشبه هنا جاء مقصودًا، وكأنه يقصد ألا يحدد المشبه لأن النص ينفتح على العديد من الشخوص خاصة تلك التي تسكن البيئة البدوية، ثم استخدامه الصفة (قديم)، يجعلنا نذهب إلى القول بأننا مع هذا العنوان بهذه التركيبة نشتم رائحة الحنين إلى الماضي والاشتياق إليه؛ فكثيرًا ما علق لحن الناي وعذوبته بالماضي والحنين الدائم إليه.
جاء الكتاب على شكل (قصص) وضم قسمين رئيسيين أراهما يحملان المعنى ونقيضه، الأول: لحن قديم يجلو الصدأ وبه (13) قصة، والثاني بعنوان: لحن البوار وبه (9) قصص، ويمكن القول أن الأديب حالفه التوفيق فيما يتعلق بهندسة هذا الكتاب واختياره للقصص داخل الكتاب؛ ففي حين لا نجد بروز هذا اللحن كلفظ أو مفردة في القسم الأول من الكتاب؛ أي لا نسمع صوت الناي صراحة في القسم الأول منه إلَّا في قصة واحدة تقريبًا وهي قصة (رفات القمر)؛ إذ يقول: “وبحركة لا إرادية يضغط أزرار ريموت الكاسيت فترتج على إيقاع لحن صاخب”، ولكنه استبدله بالذكريات التي لاذ بها واعتبرها لحن العودة إلى الماضي الجميل، وذلك على عكس القسم الثاني الذي سماه: (لحن البوار)، فهذا التركيب الإضافي المكون من المضاف وهو (لحن) والمضاف إليه (البوار) يعطيك معنى مستقرًا في ذهنك وهو أن للبوار الذي يعني الجحيم كما في قوله تعالى “وأحلوا قومهم دار البوار”، نجد هذا اللحن في غالبية قصص القسم؛ وكأنَّ المبدع استبدل الحنين والذكريات بهذا اللَّحن فنجده في أسماء بعض قصص القسم مثل (نغمات حارة)، وضمت قصص هذا القسم عديد الألحان، فعنوان الكتاب يمثل مشتركًا دلاليًّا لقصص الكتاب كله بقسميه، استند في قسمه الأول على الحنين والذكريات ليزيل وجع الحاضر وسيطرته وألمه، وفي القسم الثاني بدأنا نسمع لحن الناي الذي يعزف عزف البوار والخراب من خلال عرض نماذج من قصص الواقع التي يحياها شخوصه وأبطاله.
إذا ما توقفنا أمام القسم الأول من الكتاب الذي عنونه (لحن قديم يجلو الصدأ)؛ فنجد المؤلف في هذا القسم يتشبث بالماضي ويتدثر بثيابه؛ فيحاول بإعادة لحنه أن يجلو أو يزيل صدأ الحاضر أو الواقع الحالي الذي طغى وتجبر وتمكَّن من الكاتب.. ويؤكد ذلك ما جاء في عناوين القصص داخل هذا القسم؛ فنجد ذلك جليًّا واضحًا في قصص مثل (دور سيجا)؛ فيبدو الواقع ضاغطًا على البطل في قوله: “والسنوات توالت، وبصماتها لم تخطئها الأبصار، فثمة تجاعيد زحفت على الوجوه، والشيب لم يتوقف يومًا عن غزو الرءوس”؛ غير أنه يحاول جاهدًا الاحتماء بالذكريات التي تمده بالطاقة والحيوية في صراعه المستمر مع الواقع؛ فيتحدث عن لعبة “سيجا” وعن ذكريات البطل معها، وكيف كانت تُعقد حلقاتها لينتهي بقوله عنها: “فينتفش العجوز الفائز، ويمتعض وجه الخاسر، وتنهمر عليه سهام السخرية، فيتظاهر بالغضب، ويهمُّ بالقيام والانصراف، لولا أن رفاقه يقبضون على طرف جلبابه، ويجلسونه رغمًا عنه، فيهدأ غضبه المزعوم، وينفجر ضاحكًا”، ونجد ذلك أيضًا في قصة (مثل وردة جورية) الذي يحكي فيها عن واقع تلك المرأة الدمشقية الأربعينية التي هربت من بلادها وما تعانيه بعد مقتل زوجها وأولادها تحت القذف، فيقول على لسان البطل/ الراوي: “ودفعني الفضول أن أسألها عن بلدها، وحكايتها.تنهدتْ بحرقةٍ، وشردتْ، كأنَّها تغوص في بحر من الذكريات الحارقة، أخبرتني بأنها كانت تملك في بلدها بيتًا محاطًا بحديقة، يملؤها الورد الجوري، والحبق، والقرنفل، والياسمين”، ويستمر صراع الذات دائرًا على طول قصص القسم الأول ما بين الماضي الملاذ وبين والواقع الذي لم يعد لتلك الذات مقدرة على احتماله، فنجد ذلك في قصص (رجم الحِنَّاء)، و(جراح)، و(طريق)، و(سحاب صالح)، وفي القسم الثاني الذي وسمه بـ(لحن البوار)، فالبوار يراد به الجحيم، وكأنَّه بذلك أراد أن يعزف للجحيم لحنًا يعبر عن الهلاك وضياع الأمل واندثاره، وهو ما نجده في كل قصص القسم تقريبًا؛ متخذًا طريقًا مخالفًا للقسم الأول، وبدأ هذ القسم بقصة طغى فيها لحن البوار هذا حتى صار لحنًا جنائزيًّا، عبَّرت عنها كل الآلات الموسيقية التي وظفها داخل نصه المسمى (معارج الغزلان)، حين استدعى البطل/الراوي صورة (ريم) بوجهها الملائكي الذي يظهرها رشيقة رقيقة تغني لها عصافير الكناري، ويغار عليها الصباح، والربط الرائع بين الابنة وصورة الغزال التي يرسمها من حيث دلالة الاسم وطريقة السرد داخل القصة؛ إذ يقول على لسان الراوي: “يمور الوجع في صدري، أُنَحِّي الورقة جانبًا، ألوذ بالموسيقى؛ ألتقط هاتفي، أضغط إحدى الأيقونات، تبدأ الأوركسترا العزف، تنساب أنغام الهارب، وأنغام الكمان بهدوء ورهافة؛ تطلُّ ريم بوجهها الملائكي”، فالبطل/الراوي هنا يعمل مدرسًا للموسيقى في إحدى الدول العربية، ونجده (يلوذ بالموسيقى)، وتتردد بين مسامعه وتنساب أنغام (الهارب، والكمان، والبيانو، والترومبيت، والكونترباص، والتوبا)، وهو مع ذلك لا ينسى أبدًا موسيقاه التي هي من (لحمه ودمه)، إذ يقول: “أغلق هاتفي، ولكنَّ الجدران تفاجئني بموسيقى أخرى من لحمي ودمي، لا أدري أمن بين ثنايا الجدران، أم من صدري ينوح ذلك الناي القديم”، ويستمر في هذا القسم عزف الناي ففي قصة (ذكريات مستعملة) يقول على لسان البطل/ الراوي الذي يعيش على ما ابتاعه من ذكريات الناس التعساء: “فأنا عازف ناي، اعتدت أن أشتري من أولئك المارة المتعبين ذكرياتهم القديمة المستعملة، والتي بدورها تمنحني الرهافة، والألحان الجديدة المشبَّعة بالشجن”، وأشار فيها إلى قصة المرأة التي تعاني طيلة حياتها، ويسرد مشاهد حياتها وصور واقعها المأزوم، وهو يسجل هذا الخروج بالعزف على نايه المعد لذلك؛ فيبدو شريط حياتها كشريط سينمائي ينقله السارد وكأنه يراه رؤيا العين؛ إذ يقول على لسان السارد: “ولكنني لا أنسى تلك المرأة بالذات؛ فقد انخرطت في نوبة بكاء حارة بمجرد أن بدأ العزف، وسرعان ما خرجت الصور من رأسها بنسق متتابع مثل شريط سينمائي”؛ ثم لتنتهي القصة بمعاناة البطل/ السارد مما يعانيه الناس، فيتعطل نايه، ويصاب بالخرس، ولا يجد من يبتاع منه ذكرياته؛ إذ يقول: “رأسي يؤلمني بشدة..أشعر بأنني أحمل فوق كتفي بالونًا منتفخًا، يشتهي الانفجار، كم أرغب في الصراخ..ولا أستطيع كذلك عزف نايي، الذي أصيب فجأة بالخرس”، ولكن هل توقف صوت الناي الحزين بالشجن عند هذه القصة؟، بالطبع لا لم يتوقف؛ فنجده في (رَهْف الحديد) إذ يقول: “وقد تنامى إلى سمعه أغنية شجية ولحنٌ ناعمٌ قديمٌ أشعره بالدفء”، وكذلك في (صهيلٌ خافتٌ) نسمع صوت أم كلثوم يتردد في المكان: “تغمرهم الأضواء الخافتة، وصوت أم كلثوم يتردد في آذانهم رخيمًا شجيًّا، يعيد إلى خلاياهم شيئًا من الحياة والبهجة والصهيل”، ونسمع صوت مزماره كذلك في آخر قصة (نغمات حارة) التي تحكي قصة الشاب الجامعي الذي يبيع بالونات: ” وما إن يدخل الشارع المقابل، حتى تنطلق نغمات مزماره، تختلط بأنفاسه الحارة، تتردد في الفضاء بقوة وعنفوان”.
والذات الساردة حين تعزف لحنيها المختلفين على مدار قصصها تبرز بعض الصفات النبيلة التي لا نراها في العواصم الكبيرة والمدن المزدحمة بساكنيها؛ وإنما نراها بارزة جلية في بيئة الريف بصفة عامة، وريف الصحراء أو البدو بصفة خاصة، ففي قصة (طريق) يرفض الصبي الصغير أن ترافقه أمه في طريقه إلى المدرسة رغم خوفه الشديد وترقبه سقوط الأمطار بين لحظة وأخرى حتى لا يعيره أطفال النجع بأنه لم يصبح رجلًا بعد؛ فيقول على لسان الطفل: “عرضت علي أن ترافقني في الطريق، لكنني اعترضت بشدة؛ ففي ذلك اعتراف ضمني مني بأنني لم أصبح رجلا بعد، ذلك الاعتراف الذي سيعرضني-لا محالة- لسخرية صبيان النجع أجمعين”، وفي قصة (رصد الليل) يشير المؤلف إلى أن الحليب في مثل تلك النجوع لا يباع بل يُهدى وهو أمر لا نراه في غير هذه البيئات؛ فيقول: “ولما كان الحليب في النجع يهدى ولا يباع، صارت للأم يد بيضاء على جاراتها اللائي رحن يتوددن إليها رغم ما في قلوبهن من غيرة”، وفي قصة (صخب): “أن يعايرك أحدهم بالجبن لأمر أشد إيلامًا من عضة ثعبان، تلك عقيدة رسخت في قلوب صبيان النجع”، وفي قصة (أعشاش) يشير الترابط الوثيق الذي يربط بين أهالي النجع بعضهم بعضًا؛ إذ يبرز ذلك من خلال قوله على لسان المرأة الستينية: “جميعهم يلقبونني بكلمة أمي، يذكرونها قبل اسمي مباشرة…بينما تتناوب بنات النجع على خدمتي، هذا سر بقائي على قيد الحياة إلى الآن..”.
والذات الساردة في (كبوح ناي قديم) تتخذ من اللغة وسيلتها التي تعبر من حلالها وبصورة ملفتة عن عالم له طبيعته الخاصة خاصة القسم الأول منه، ثم قصة واحدة تقريبًا من القسم الثاني وهي قصة (في قلبه زهرة عباد)، وهو عالم البيئة الصحراوية أو البادية، الذي غالبًا ما يمتلئ بالوحشة والأساطير والغرابة، واستطاع الكاتب أن يسبر أغوارها ويغوص في رمالها، ويخالط رجالها ونساءها، وشبابها، وشيوخها، واستطاع أن يخرج منها بكنوزٍ ودرر، ليعكس في نهاية المطاف فلسفته ويلخص رؤيته للعالم والوجود من تلك الزاوية التي ينظر منها، أو لنقل من تلك النافذة التي يفتحها على مصراعيها؛ فبرغم قسوة البيئة الصحراوية ووعورتها تمكَّن الصباغ أن يرسم صورتها، ويعبر عن تجربتها باستخدامه الصور الفنية المنتزعة من البيئة؛ فلم تأت غريبة عنها، فتذخر المجموعة القصصية ومعجمعها اللغوي بمفردات البيئة البدوية الصحراوية، التي ينحت منها الكاتب مادة قصصه وحكاياته، فتبدو ذات صبغة خاصة تشير إلى المكان بوصفه تلك البقعة الجغرافية ذات الطبيعة شديدة الخصوصية؛ فتبدو بذلك علامة واضحة جلية تشير إلى المكان وطبيعته البيئية؛ فنجد (أشجار الجازورين، لعبة سيجا، النجع، عراجين النخيل، التوت، الحناء، والشتاوي وغناوي العلم والمجاريد، الحجل، مساطب الدور الطينية، سبت الخوص، المنجل، أفران الحطب، رياح الخماسين، القوالح، سروال البفته الأبيض، والصديري، الخفير، مربد، مربط، عريش، جريد، رتينة الكلوب، الفتَّالة، الحمار، الكبش، النعاج، البيَّارة، حظيرة، الكرملة، والنوجا والعسلية، السعف، والجريد، بوابير الجاز، والكوانين، أحراش البوص، والحلفا، والبرنوف، الجريد، الماشية، حصيرة السمر، الجبن القريش، المورتة، الحليب، الخزانة الخشبية (الساندرا)، السمن البلدي، الإدام الدسم، برام الأرز المدسوس، فرن الحطب، بقرة، الحبل، عجل، حزم البرسيم والدريس، الروث، الخطام، أشجار السنط، ماكينات الري، رعي الأغنام، مزارع العنب والموالح، خراطيم الري بالتنقيط، مقاولي الأنفار، قِطَع الخيش)، وعلى الرغم من خصوصية تلك المفردات إلا أنها لم تأت غريبة، أو عصية الفهم على القارىء العادي.
تمتاز المجموعة بجمال اللغة ودقة الوصف، فنجد فيها العديد من التعابير الموحية والمعتمدة على المجاز والتشبيه والاستعارة بوصفهم من أدوات التصوير، وهي مع ذلك منتزعة من البيئة المكانية للأبطال والشخوص: فنرى النجع جثة شاحبة، بعد أن قتلها الهجر والسكون في قوله:”ففي مثل هذا الوقت من النهار يظهر النجع مثل جثة شاحبة، قتلها الهجر والسكون”، وبالمجاز أضحى هذا العجوز المسن “يجرجر قدميه العصيتين”، فلك أن تنظر إلى وقع الفعل يجرجر بصيغته المضارعة مع القدمين العصيتين عن الحركة، وانظر إلى جمال التعبير في قوله على لسان الراوي/ السارد: “لدي بنت وولدان، ثلاث حبَّات من التوت، يبددون مرارة الأيام أحيانًا” فجمال التعبير هنا ليس في التشبيه في حد ذاته؛ وإنما في طريقة صوغه إذ شبه هؤلاء الأبناء بالتوت الذي هو من مفردات بيئته الصحراوية؛ فيعطيك التعبير جمالًا فوق جماله؛ ثم انظر كذلك للتعبير الأخير من القصة حين يقول على لسان الراوي/ البطل: “لم أستطع أن أتابعها هذه المرة، خفضت بصري، .. ولم أشعر إلا ودمعتان ساخنتان تتدحرجان على خدي، تسقطان على كراسة، وقلم، وممحاة”، فهذا التعبير في نظري يختزل العديد من التعابير؛ واستخدامه “لم أستطع” التي توحي بالعجز؛ ثم التعبير بالفعل “خفضت” يلخص رؤية الكاتب وتجربة تلك المرأة، وكذلك قوله “تخرج العروس من دارها كنجمة في أوج الزينة..تفاجيء الليل الناعس؛ فيستيقظ..” واستخدامه النجمة كمشبه به هنا وهي مفردة لها دلالتها ووقعها في أدب الصحراء.
وهو لا يتوقف عند هذا الحد؛ إذ يسعى إلى رسم صورة كلية تحضر فيها كل ما يحيط به من مظاهر وتشارك في تشكيل الصورة ورسم اللوحة الفنية كاملة؛ فيقول في قصة (رجم الحناء): ” وفي ليال حالكة الظلام، وُلِدَ من نسل أصحاب المساطب والظلال بنون وحفدة يكرهون الضوء، ولا تضحك وجوههم للشمس..”؛ فقوله “من نسل أصحاب المساطب” كناية عن هؤلاء الذين لم ينشغلوا إلا بالنميمة وكأنهم دخلاء على هذا المجتمع؛ فبظهورهم أضحى نهار النجع متربًا برياح الخماسين، وغدت اتهاماتهم لتلك المرأة بكلماتهم الجارحة التي تنزل على مسامعها “كما تنزل السياط على الظهر العاري”؛ ثم يكمل اللوحة التي رسمها لتلك المرأة بعدما تعرضت له من الضرب والإيزاء من هؤلاء الدخلاء الذين “رفعوا عصواتهم، وهووا بها على بدن المرأة، التي استغاثت بأهالي النجع، لكنَّ أحدًا منهم لم يغثها، بل لاذو جميعًا بالصمت”، فما كان من المرأة إلا أن تكورت فوق الرمل؛ والسارد حين يصف حالتها هذه يستجمع كل مظاهر الطبيعة حوله من أجل رسم تلك اللوحة الحزينة التي تسجل تعاطفها مع تلك المرأة بعد أن تخلى عنها أهل النجع التي عاشت بينهم؛ فنجد (الحر غليظًا، والشمس حارقة، والغبار كثيفًا ساخنًا، والوقت متجمدًا)، كما (شحبت النجوم، وصمتت الملاعق وآنية النحاس، وانظفأت العرائس، وخيم على النجع الوحشة والسكون)، وبذلك استطاع المبدع أن ينتزع تعاطف الطبيعة جميعها مع تلك المرأة؛ فيقول في آخر القصة: “منذ ذلك اليوم البعيد شحبت النجوم، ما عادت تضيء سماء النجع، وصمتت الملاعق وآنية النحاس، وخاصمت الأغنيات والمجاريد الحناجر..في حين انطفأت العرائس، ما عدن لامعات”.
تتوالى عند المبدع التصاوير المنتزعة من مفردات البيئة البدوية؛ فيأتي طرفي الصورة من تلك البيئة؛ وهي تصاوير واضحة لا تحتاج إلى شرح؛ فلننظر مثلًا إلى قوله في قصة (جراح): “ولما كانت الأيام مثل الخيول تجيد الركض”، فيشبه الأيام بالخيول التي هي من كائنات البيئة، ثم التناسب بينه وبين التعبير الذي يقول فيه: “باغته الشباب سريعًا، والشاب العفي مليح القسمات، صهل في عروقه ألف جواد”، وكذلك التعبير بقوله: “كانت السماء كالأفق البعيد مسودة معبأة بالغبار والدخان، وكانت الطائرات تحصد الهائمين على وجوههم كأنهم عيدان شعير ألقتها في قلب الصحراء يد مرتعشة”، وقوله في قصة (سحاب صالح): “ولما كانت الأيام كالسواقي، لا تكف عن الدوران”، وقوله: “ضرب المرض قوائم الفرس العفي”، وقوله في قصة طريق “رغم ما بي من رعب، ألتقط حجرًا غائصًا في الأرض الموحلة، أمسح الطين العالق به، أمرره عدة مرات فوق العشب المبتل النامي على حافة الطريق، أتشجع؛ فقد قبضت للتو على سلاح ربما يدفع عني الكلاب الشرسة”، فيصبح الحجر في يد هذا الطفل سلاحًا يدافع به عن نفسه ضد الكلاب الشرسة التي تتربص به، والسلاح / الحجر من مفردات البيئة الصحراوية، وتكثر التشابيه المعقودة من البيئة على طول المجموعة خاصة في قسمها الأول مثل قوله: “أتحول إلى عصفور أوشك أن يطير”، و”سينقطع عن دارها الرائب والحليب”، وقوله: “ليلتها عوت الريح”، وقوله على لسان السارد حين يشبه ابنته بالغزال، التي تغني لها عصافير الكناري، ويغار عليها الصباح: “تخطر ريم في طريقها إلى كليتها رشيقة كما الغزلان، رقيقة كما النسرين، تغني لها عصافير الكناري، ويغار عليها الصباح”، وفي قصة (غواية): “يراني الصباح على تلك الحال؛ فيرشقني بحصوات نِبْلِهِ” ، وقوله: “أصل إلى مقر عملي كفرخ دائخ”، وبذلك تكون التصاوير التي رسمها المبدع لأبطاله داخل القصص جميعها مقتبسة من مفردات البيئة المحيطة به مما أضفى عليها جمالًا وجعلها أكثر قبولًا عند القاريء .
أما بالنسبة للمكان لا تجد صعوبة في تحديد أبعاد المكان التي تتعرض له هذه المجموعة؛ إذ تبدو معالمه واضحة جلية سواء بالتصريح أو حتى بالتلويح؛ فالتصريح نجد الراوي يصرح بالمكان غير مرة فيقول (النجع)، وفي قصة (مثل وردة جورية) يقول على لسان الراوي وهو يخبر عن تلك المرأة الأربعينية: “حينما خاطبتْ بها سائق التوكتوك الذي أقلها إلى داخل مدينتنا الصحراوية”، وفي القصة نفسها يحدد المكان تحديدًا أكثر دقة إذ يقول على لسان الراوي نفسه: “ولما كانت مدينتي قريبة من مدينة الإسكندرية؛ حيث تباع البضائع في حي المنشية”، والتلويح في إشارته للنجع وذكر بعض العادات والتقاليد التي تذخر بها تلك النجوع المترامية على أطراف البيئة الصحراوية؛ فيقول مثلًا في (رجم الحناء): “وتشدو الحناجر بـ الشتاوي، وغناوي العلم، والمجاريد”، ونجد كذلك “حلقات الحجل”، وكثرة ذكر “أشجار الجازوين”، والإشارة إلى “الدور الطينية”، و”أفران الحطب المشتعلة في أفنية الدور”.
وتبدو رمزية اليمام وتوظيفها داخل القصص، دلالة واضحة على المكان؛ فلك أن تتخيل تكرار هذا الرمز في قصة واحدة وهي قصة (أعشاش) أربع مرات، إذ إن قد ذكرها يهيج مشاعر الحزن نحو الأحباب المفقودين، وربما استدعاها الكاتب تفاؤلًا بعودة الغائبين، والإشارة إلى الأمل وتجدده واستمراره، فيقول على لسان العجوز: “وأراه تارة أخرى يحلق في السماء بصحبة عصافير ويمام وهداهد”، ويقول: “وراح اليمام يحط على شجرة تين.. ولما كانت من عادة اليمام أن يتوقَّف عن السجع كلما نزل المطر، تعجبت عندما سمعت اليمام يسرف في السجع رغم هطول الأمطار”، ويختتم به كذلك النص بقوله على لسان الراوي : “ورحتُ أصغي بإمعان إلى سجع اليمام الذي استقر أخيرًا داخل أعشاشه الدافئة…”، وغدا هذا الرمز أثيرًا لدى المؤلف؛ فاستخدمه كذلك في قصة (رفات القمر): “تسير شاردة، ولا تأبه هذه المرة بنظرات المارة، ولا تكثر التلفت جهة اليمين، وجهة اليسار مثل يمامة مذعورة أفزعتها القطط الجائعة التي تحدق بها من كل ناحية”، كما نجده يحتل عنوان مجموعتين قصصيتين للمبدع؛ الأولى: “يمام الوجد”، والثانية: “بخفة عصفور وحزن يمامة”؛ فيبدو أنه مغرمًا بسجعه الذي تألفه وتطرب له الآذان لمجرد سماعه.
أما عن رسم الشخصية داخل قصص المجموعة؛ فقد برع الكاتب في رسم أبطال قصصه، ووصف حالتهم النفسية والربط بين الشخصية والجو النفسي المصاحب لها؛ نجد ذلك في عدد كبير من قصص المجموعة؛ ومن ذلك على سبيل المثال قصة (طريق)؛ فانظر مثلًا إلى وصفه لذلك الطفل/الراوي وهو في طريقه إلى المدرسة وقد وصل إلى الأسفلت بقوله على لسانه: “وما إن أرى الأسفلت، حتى أتنفس الصعداء، وأسير مبتهجًا بعد أن أمنت شر الكلاب، وتخلَّصت من كدر الخوض في الوحل..وتظهر المدرسة على مرمى البصر، فيخفق قلبي طربًا، وأجدُّ في السير، فيفاجئني المزن برذاذه الخفيف، يتساقط فوق رأسي، أبصر العصافير تحط على الأشجار المنتشرة على جانبي الطريق، تهز رءوسها، وتحرك أجنحتها، وتنفض ما علق بها من ماء، ثم تعاود التحليق، أهز رأسي مبتهجًا، أفتح زراعيَّ، أضرب بهما الهواء، أركض بأقصى سرعة..أتحول إلى عصفور، أوشك أن يطير”، فتلك اللوحة التي رسمها المبدع في وصف حال هذا الطفل وقد لاحت المدرسة أمام ناظريه منبعثة من الحالة الشعورية التي يحياها هذا البطل، وتلك الحالة التي جعلت الأديب يوظف كل طاقات الطبيعة لنقل هذا الشعور، وكأنها ترحب به وبإصراره على القدوم إلى المدرسة على الرغم من هذا الجو الملبد بالغيوم والأمطار، فيتحول هطول المطر بغزارة دون انقطاع إلى (رذاذ خفيف يتساقط على رأسه) وكأنه يداعبه، وتستقبله كذلك (العصافير) التي تحط على جانبي الطريق و”تهز رءوسها”، وكأنه ترحب به وبقدومه أيضًا، كما أنه في طريقه (يبصر الكلاب منكمشة غافية كأنها رقَّت لحاله).
ونجد ذلك أيضًا في قصة (دور سيجا) حين يصف هذا الشيخ الذي تقدم به السن؛ وقد طغى هذا الوصف على المظاهر التي تحيط به؛ فيقول: “يخرج من داره ضحى، يتوكأ على عصاه، يسير بتمهل، يئن من فرط الوجع، منذ متى صارت قدماه خؤونتين إلى هذه الدرجة، ومملتين إلى حد الضجر، لا تمنحانه سوى الألم؟! يجرجرهما قسرًا” وانتقل الوصف أو حالة تلك الشخصية إلى الظواهر حوله: “يحدِّق إلى الشارع الخالي من المارة؛ ففي مثل هذا الوقت من النهار يظهر النجع مثل جثة شاحبة، قتلها الهجر والسكون..حتى الكلاب الضالة، والقطط انسحبت إلى أماكنها السرية الظليلة”.
يحمد للأديب كذلك جمال صياغة العبارات السردية، وطريقة استخدامه الأفعال؛ فتأتي العبارات شديدة التكثيف، معبرة موحية لدرجة أنه لا يمكنك أن تزيح بعض هذه الأفعال عن أماكنها، ولنضرب عن ذلك بمثالين أو ثلاثة والأمثلة كثيرة جدًا، في قصة (غواية) وهو يتحدث عن تجربة المبدع وحاله مع ما يكتب ويبدع وهو يعاني من ضغط الواقع وتحدياته المعيشية يقول على لسان السارد: “أدخل لاهثًا، ألتقط أنفاسي بصعوبة، أستنشق روائح الأدوية النفاذة، أشعر بالدُّوار”، فانظر إلى استخدامه الأفعال وترتيبها في الجمل، ووقعها على الأذن، وفي قصة (نغمات حارة): نجده يرسم مخططًا ليوم هذا الشاب من بدايته لنهايته بعدد من الأفعال المتتالية ضمن عدد من الجمل السردية المركزة؛ فيقول: “يجتاز باب البيت الصديء، يسير مطرقًا إلى الأرض، يشق الشارع الضيق، يصل إلى الميدان الواسع، يجلس على حافة سور النافورة الحجري، يُخرج كيسًا مكتظًّا بالبلونات، ينفخها الواحدة تلو الأخرى، ويعلقها في طرف عصا طويلة بخيوط رفيعة، ثم يحمل عصاه على كتفه، ويبدأ جولته اليومية”، وانظر لتوالي الأفعال المضارعة في قفلة القصة: (يذيب، يتصبب، يهز، لا يتفوه، يسير، تتنازعه، يبيع، تصبح، ينفض، ينهي، يصل، يتسمر، …).
أما عن الراوي في المجموعة فنجده يتوزع بين عدة رواة؛ منهم الراوي الذي يأتي أحيانًا بضمير الغائب؛ إذ نجد ذلك في قصص (دور سيجا)، (رجم الحناء)، و(جراح)، و(البيارة)، و(سحاب صالح)، (رصد الليل)، و(صخب)، و(هواء راكد)، و(صهيل النور)، و( رفات القمر)، و(صهيل خافت)، و(في قلبه زهرة عباد)، و(نغمات حارة)، و(غروب تدريجي)، و(عصافير جهنم)، والراوي الذي يأتي بضمير المتكلم (مثل وردة جورية)، و(أعشاش)، و(معارج الغزلان)، و(غواية)، و(ذكريات مستعملة)، و(رهف الحديد)، والراوي المؤلف الذي يبدو جليًّا واضحًا في عدد من القصص، فنسمع صوت المؤلف يطل من خلال القصة؛ فنشعر وكأن كرم الصباغ هو من يتحدث في النص مثل نص (الطريق) الذي يحكي على لسان طفل في أحد النجوع وهو في طريقه إلى المدرسة في يوم مطير، ونشعر بالأبطال كأنهم أحياء بيننا، بداية بالأم، ومرورًا بالأستاذ عثمان مدرس اللغة العربية، الذي طالما كتب له بخط يده كلمة الصباح على صفحة أو صفحتين من ورق الفولسكاب، وكذلك حديثه عن الأستاذ سيد مدرس الألعاب، وهيبة الأستاذ مفتاح ناظر المدرسة، والأبلة أماني مدرسة الرسم، والأستاذ عيد سيف النصر مدرس العلوم الذي أهداه أول كتاب قرأة وهو كتاب (البخلاء) للجاحظ، ثم كان جوازه من الأبلة سحر معلمة الدراسات الاجتماعية، فذكره تلك العائلة المدرسية يجعلني أوقن أنها أسماء حقيقية تمامًا، وأن الراوي البطل هنا هو الصباغ نفسه .
تعبر قصص المجموعة عن الحدث وتهتم كذلك بجمال التعبير عنه أي تهتم بـ(الشكل والمضمون/ اللفظ والمعنى)؛ فلا يهمل المؤلف جانبًا على حساب جانب آخر؛ ويضع القاريء في حالة من التشويق المستمر التي تُزيد ارتباطه بالقصة، وتجعله لا يبرح عنها حتى ينتهي من القراءة كاملة، وليس هذا فحسب، وإنما حين ينتهي من القراءة لا يملك إلا أن يصفق للمبدع شكلًا ومضمونًا؛ فالمبدع حريص كل الحرص على أن يمسك بتلابيب القاريء، ويدفعه دفعًا أن يتمَّ ما بدأه من القراءة؛ ويقوم ذلك على دقة اختياره للمشهد الافتتاحي، فيثير فضول القارئ، ويزيد من تشويقه ويدفعه إلى إتمام القراءة ليقف على مراد الكاتب، وهذا ما يسمى “بالحبكة الفنية”؛ حيث أن الحبكة هي المسؤول الأساسي عن ترتيب أحداث القصة، وربط بعضها ببعض بصورة تجعل الأحداث أكثر إثارة وتناسقًا، وتعتبر كذلك هي المجرى العام لأحداث القصة التي تحدث بشكل متسارع ومتنامي، والتي يمكن أن نسميها (هندسة بناء القصص)؛ فهو عادة لا يبدأ القصص ببدايات تقليدية؛ وإنما يسعى في قصصه إلى إحداث الدهشة وجذب القاريء وإمتاعه في آن واحد؛ فنجد ذلك في قصص مثل: (سحاب صالح)، و(رصد الليل)، و(أعشاش)، و(هواء راكد)؛ لو أخذنا قصة (رصد الليل) مثالًا، فإنك ستقف متسائلًا عن العنوان: ماذا يقصد بـ رصد الليل؟، ثم تبدأ في قراءة الأسطر الأولى من القصة؛ فبدلًا من أن يريحك ويعطيك الإجابة يزيد من تساؤلاتك واستفهاماتك عن مقصد الأديب؛ إذ يأتي الحديث مستخدمًا تقنية الراوي العليم الذي يتحدث بضمير الغائب عن تلك المرأة التي (جثت على ركبتيها/ وبدت ملتاعة إلى أقصى درجة/ راحت تنعي حظ أبنائها/ مشفقة عليهم من عسر، لم يألفوا مثله من قبل/ اخترق عويلها سمعهم../فأبصره واجمًا مطرقًا إلى الأرض/صامتًا يسمع عويل زوجته/ وعباراتها الجارحة.. بدا أبوه مهزومًا/ قد اكتسى وجهه بالحزن/ وقد أطلت من عينيه نظرة مشوبة بالخزي) وتستمر الجمل السردية المتلاحقة والمتسارعة التي ما إن تقرأ إحداها إلا وتدفعك لقراءة غيرها بغية الوقوف على فكرة القصة ومعرفة مراد الكاتب؛ فتستفرغ الصفحة الأولى من القصة، وتتبعها بنصف الصفحة الثانية أيضًا؛ حتى تصل إلى قوله على لسان الراوي “في تلك الدار بقرة مباركة” فتبدأ الأمور تنكشف لك شيئًا فشيئًا، فتعاود قراءة ما قرأت لعلك تتمكن من فهم القصة؛ وكأنك تتحدى الأديب في أنك ستمسك بأطراف القصة بعد وقوعك على الخيط الأول منها، فتتوقع أن البقرة أصابها مكروه ما؛ ربما مرضت، أو ماتت؛ فحرموا تبعًا لذلك مما كانت تجود عليهم به من الحليب، والجبن القريش، والمورتة؛ ثم نكتشف في نهاية القصة أنها سُرقت من أولئك الذين نقبوا حائط الحظيرة الطيني وسرقوها ليلًا.
كذلك الأمر في قصة (أعشاش) إذ يحدثنا عن تلك المرأة التي تعد أمًّا لأبناء النجع كله بعد هجرة ولدها وغيابه عن حضنها فترة من العمر؛ فأنت حين تقرأ تظل تنتقل من جملة سردية إلى أخرى من أجل أن تفهم فكرة القصة والمضمون التي تسعى لإبرازه؛ فلا يعطيك هذا الخيط سوى بعد صفحة ونصف تقريبًا حين يقول على لسانها: “إلا أن ولدي الوحيد لم يكن ذلك النوع القانع..لم يشأ أن يعيش سائر عمره تحت إمرة أصحاب المزارع، ومقاولي الأنفار، الذين يمتصون دماء العمال..”، وفي قصة (معارج الغزلان) تبدو البراعة في رسم المشاهد بين بداية القصة وخاتمتها، فنراه في بداية القصة يحكي عن بطل يلتقط بعض الأوراق ليرسم عليها غزالة بعد أن يلوذ بصمته وعزلته ويري الوجوه مرايا مهشمة، ثم يبدأ في سماع ألحان مختلفة عن طريق الهاتف، يستدعي من خلالها ابنته ريم ويصف حالتها، ليفاجئنا في النهاية أنها ماتت بحادث سيارة، وكل هذا الوصف وموسيقى الهاتف تعزف على مسامعه بألحان مختلفة، لتنتهي ألحان هذا الهاتف بذلك اللحن الجنائزي، فيغلق الهاتف، لتباغته الجدران وقد عاد لواقعه الذي بدأ به القصة، وفي قصة (هواء راكد) اتبع في رسم حبكته الفنية على فكرة المفارقة المدهشة؛ إذ نجد أن القصة كلها كانت حلم داخل حلم، ليباغتنا في آخر القصة بعد أن ينقل لنا حال تلك الزوجة التي تنتظر حملها الأول منذ سنوات ونتيجة لتأخره تحولت الدار إلى مقبرة غلب عليها الوحشة والسكون، وفي القصة يتحقق ذلك فتدخل الزوجة وتفتح شباك الغرفة على زوجها وهو نائم فيستيقظ، ويسألها عما تفعله؛ فتخبره بأن القابلة قد بشرتها بحملها، وتبدأ في إخراج ذلك الصندوق الذي احتفظت به لسنوات وفيه ملابس للمولود الجديد؛ ثم يفاجئنا بقوله: “مرَّت لحظات أرقص الفرح خلالها قلب الزوج، لكنه انتبه بعدها مذهولًا؛ إذ وجد نفسه لا يزال في فراشه، تطبق عليه العتمة من كل جانب، فراح يلتهم الظلام بعينيه، وبعد لحظات من التحديق استطاع أن يبصر الخزانة المغلقة” .